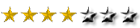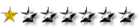محبة المسيح غربتني
تخرج (ياسر) في الخمسينات من كلية الهندسة, والتحق بالعمل في شركة أجنبية بالإسكندرية, وقد تجاوز راتبه الشهري آنذاك (المائة جنية), وكان وحيداً لأسرة موسرة لها أملاك واسعة وعدة أرصدة في البنوك, وربما كان هذا هو السبب في أنه اعتاد أن ينفق ببذخ ويحيا حياة أرستقراطية مترفة, وأمّا البعد الروحي له فقد كان باهتاً .. كانت له إهتمامات أخرى.
فقد ألف الحفلات والسهرات, يخرج في الثامنة مساءاً, ليعود عند الفجر, وأمّا أفراد أسرته فقد كانوا لاهون أحدهم عن الباقين – كان لكل منهم عالمه الذي يغوص فيه.
وعرف بعض الآباء الطريق إلى منزلهم, وزاروهم مرة وإثنتين, ونصحوهم بالإلتفات إلى خلاص نفوسهم والاهتمام بحياتهم الروحية, ووعدوهم خيراً, غير أن اهتمامات العالم عادت لتحوطهم وتحاصرهم من جديد.
في ذات مساء تقابل ياسر مع أحد الآباء الرهبان, كان الراهب واقفاً على رصيف إحدى المحطات في طريقه إلى "مستشفي ﭭيكتوريا", فرق قبله له, وأوقف سيارته وداعاه ليركب معه ينقله إلى حيث يشاء, ولكن الراهب تمنع قليلاً في حياء قبل أن يصعد إلى جانبه, ولم يقل طوال الطريق الذي أستغرق نصف الساعة,سوى اسم المستشفي, وحالما هبط الأب من السيارة, أنطلق ياسر إلى حيث كان أصدقاؤه ينتظرونه, وأكمل ليلته كما تعود أن يقضيها.
في تلك الليلة, عندما لجأ إلى سريره لينام, داعبت مخيلته صورة الراهب, فتعجب .. وشرد بذهنه قليلاً, فتخيل لو أنه صار راهباً..!!, ولكنه سرعان ما سخر من نفسه ضاحكاً, ولطم خدّه لطمه خفيفة, يعاتب بها نفسه.
كان أبعد ما يمكن من أن يترهّب !, لقد سمع عن الرهبان الكثير والكثير, فسمع أنهم يموتون ويفنون بعيداً عن مدافن أسرهم وربما لا يدري أهل الراهب بموته إلا بعد مدة طويلة (شيء مؤلم) وعرف أنهم يحيون داخل جدران أربع, لا نزهات ولا حفلات ولا أصوات طرب ومرح .. بل ذرف دمع .. وقرع صدر .. سجود دائم حزن دائم .. مسوح .. رماد .. نحيب, والشعر مخفي, والملابس سوداء, ... شيء يفوق الوصف .. تعب لا ينتهي !!
وإنزعج وحاول طرد هذه الأفكار لينام .. فنام.
لقد كان يشترى ملابساً كاملة كل شهرين ! حتى تكدّس صوان ملابسه بعشران الأطقم, ما أن يري شيئاً جديداً على جسد آخر, أو في ﭭترينات العرض, حتى يسارع بإقتناء مثله, عدا الروائح والمشغولات الذهبية وإسرافه في الطعام والشراب, ولقد إمتلأت حجرته الخاصة الفسيحة في منزلهم بكل ما تتخيله وما لا تتخيله.
وتــرهب ياسر!!!
وفوجئنا جميعاً بذلك, ولم نجد مبرراً لهذا التغيير الطارئ, ولا يمكن أن يقال أنه أعّد ذاته لتلك الحياة, والدليل على ذلك أن كل شيء في الحياة الديرية كان جديداً عليه.
فقد سأل هناك – في اليوم الثاني أو اليوم الثالث لدخوله الدير – ماذا تعني كلمة ميطانية؟ وإذا صادفني راهب في الطريق فماذا أقول له, وماذا يقول الراهب لأخيه عندما يصافحه في الكنيسة, إضافة إلى أسئلة كثيرة تتعلق بالبديهيات.
وقد تكبّد في الرهبنة أتعاباً شديدة, لقد أسند إليه المسئولين في الدير, أن يعمل في تنظيف حمامات الدير وبعض مواضع أخرى, فكان يقضي شطراً كبيراً من يومه في ذلك العمل, وشيئاً فشيئاً يبس جلد يديه وإمتلأت ملابسة بالبقع وإتسخ وجهه, لقد صرف ليلة كاملة حتى الثالثة صباحاً – حين دق ناقوص التسبحة – وهو يقوم بتفريغ خزان الحمامات (الترانش).
كانت نفسه تصعب عليه كثيراً فينتحي جانباً ليبكي بمرارة ولا يكّف قبل أن يشيع الله الطمأنينة في قبله, لقد كان في حياته السابقة مدللاً إلى حد غير مقبول, وعندما شاهدته أمه على حين غرة وهو في ملابسه القذرة وبؤس حاله, بكت مشفقة عليه مما هو فيه. وقد قابل شفتها بصمت مطبق وملامح هادئة وعينين مرخيتين.
فبعد أن كان يحيا في بحبوحة من العيش في منزل كبير عريق, تعمل فيه عدة خادمات وطباخ وسائق وعامل حديقة, الآن يحيا حياة العوز فقد كانت قلايته هو الأكثر بساطة بين قلالي الرهبان, وكنت تراه جالساً فيها فوق حصير بالٍ, يرتق جورباً أو يركب زراراً لثيابه, وكان ما يزال في الثامنة والعشرين من عمره.
أمّا أسرته والتي روّعت لخبر رهبنته, فكانت تحضر له بين الحين والحين يزورونه حاملين معهم طعاماً شهياً أعدّوه, وملابساً مناسبة وبعض الهدايا له, مع هبات أخرى للدير, إضافة إلى دموع غزيرة يسكبونها في حضرته وهم جلوس معه.
وكان هو إزاء ذلك, متجلداً قوياً, يطلب إليهم في إتضاع أن يصلوا عنه, ثم يوزع كل ما أحضروه من طعام وملابس وهدايا, مكتفياً بما يقدمه له الدير.
هذا وقد اتخذت الشياطين من هذا الفارق الشديد, بين حياته في العالم وحياته في الدير, مادة هامة وغزيرة وخطيرة, في حربهم معه, فقد استطاعوا أن يجمعوا كل مواقف حياته الهانئة السهلة الناعمة منذ طفولته حتى تركه للعالم, وصاروا يوجهونها إليه كالسهام, بني الآن والآخر لكي يقلقوه, مختارين أشد الأوقات حرجاً وضعفاً بالنسبة له.
وأما هو فقد كان مسكيناً يتألم ويبكي, وينظر إلى صورة السيد المسيح, تلك الصورة التي يري فيها السيد المسيح واضعاً الكتاب في شماله ورافعاً سبابته اليمني, ينظر إليها في صمت ودونما كلام .. ثم يهدأ ويبتسم حالماً يخيل إليه أن الله يطمئنه بأنه معه.
لقد كان يخجل من كثرة الطلب إلى الله ! .. يخجل من الإلحاح ! .. فيكتفي بالنظر, أو بتقبيل الصورة فيسرى السلام بين جنباته.
وكان بعض من أصدقائه, وكلهم من طبقة الأغنياء, يأتونه بين آن وآخر, في سيارتهم الفارهة, ليس على سبيل الوفاء فقط, بما تقتضيه الصداقة, وإنما رغبة منهم كذلك في الإطلال على تلك الحياة التي اختارها رفيقهم فجأة ودون مبرر مقبول في نظرهم, وحقيقي أن مثل تلك الزيارات كانت تحرك أوجاعه قليلاً, في بدايتها إلا أنها فقدت سلطانها عليه بعد ذلك.
في ذات مرة وبينما هو يجلس تحت أشعة الشمس يقرأ في الكتاب المقدس, ويضع خطوطاً خفيفة, جاءه من أخبره بأن عمه قد وصل في أمر هام, فلما انتحي به جانباً عرف منه خبر انتقال والده, وفزع .. وصمت طويلاً, وتجلد لكي يخفي انفعالاته, غير أنها كانت أكبر من احتماله فبكي منتحباً .. ولما هدأ وعرض عليه عمه أن يرافقه ليخفف عن أمّه وأختيه, أعتذر وتمنع في جدية وحياء.
وظل شارداً قلقاً, إلى أن جاء عمه مره أخرى بعد مرور أربعين يوماً, ولكن بصحبة والدته وأختيه في هذه المرة, كانت أثار الحزن بادية على ملابسهم ووجوههم وأصواتهم, وقبل إنصرافهم طلبوا إليه أن يصحبهم لإنهاء إجراءات الإرث, ولكنه رفض بشدة قائلاً "إن ميتاً لا يرث ميتاً" إمضوا وإصنعوا ما يحلو لكم, لأنه لا رأي لي في ذلك, بل إني مستعد للإقرار بتحويل كافة حقوقي لكم, وحاولوا ثانية, ولكنهم أمام إصراره تركوه وشأنه.
واتجهوا إلى رئيس الدير, يعرضون عليه تقديم نصيبه إلى الدير, وكذلك سيارته التي كانت لا تزال موجودة, ولكن الأب الرئيس أبي ذلك بشدة .. وألحت الأسرة فلم يجنوا إلا زيادة الإصرار على الاعتذار مع مزيد من الشكر والدعاء.
ومرت شهور وسنوات .. وصار راهباً محبوباً .. نشيطاً .. مطيعاً, كان يذكر الأباء ببنيامين الإبن الأصغر لأبينا يعقوب .. يأتي في هدوء ويرحل في هدوء ... لا يشعر أحد بوجوده ولا برحيله .. تماماً مثل النسيم .. منهج في حضوره ككوب الماء البارد في قيظ الظهيرة...
ومع أنه لم يكن يفكر قط في عامه المقبل أو غده, يعيش يوماً بيوم, إلا أنه صار هدفاً هاماً للشيطان .. الشيطان الذي يصطاد الضعفاء مثل صغار السمك ... بينما يقف طويلاً أمام سمكة كبيرة ... وهكذا تركزت عليه الحرب طوال الخمس سنوات التي قضاها في الدير ..
وهاجمته الأفكار الشريرة بلا هوادة .. فكر في دراسته .. وفي عمله .. ثم في الراتب الكبير الذي كان يتقاضاه, ثم في الفتاة التي أملت يوماً ما أن ترتبط به ... في الكازينو الذي إعتاد – لفترة طويلة – السهر فيه مع مجموعة من أصدقائه..
كان ما يزال في الثلاثين من عمره ... وعندما تذكر ذلك إنزعج حين تصور أنه سيحيا على تلك الحال إلى سن السبعين مثلاً...
وقال في حرقة: إن لم يبن الرب داخلي, بناءاً مستمراً فلن أستطيع المواصلة في هذه البرية.
والحقيقة أن تلك الليلة, كانت من أقسي الليالي التي مرت به في الدير, وقال ما قاله القديس موسي الأسود حين مرّ بمثل تلك الحرب (يارب أنت تعرف إنى أريد أن أخلص ولكن الأفكار لا تتركني ..).
ونظر إلى الصورة المعلقة على الحائط الشرقي لقلايته, فلم يشعر بتلك المشاعر اللذيذة التي كانت تسرى فيه كلما نظر إليها, وزاده كآبة على ذلك, السماء المكفهرة في الخارج الريح الذي يزأر مولولاً, والأمطار التي تهطل بغزارة في ذلك الوقت المتأخر من الليل..
ووقف أمام الصورة, يبث إلى سيده لواعج نفسه, فلم ينل تلك الراحة التي إعتادها, فلما ازداد قصف الرعد في الخارج عاد إلى مرقده وإندس في فراشه البالي وجلس مسنداً رأسه إلى راحتيه المتشابكتين خلفها .. وطن أن سينام, ولكن النوم عصي عليه, فحسب كتاباً ليقرأ فيه, ولكنه سرعان ما إكتشف شروده فعاد وأغلقه ووضعه في رفق جانبه.
وجاءه فكر أن الشياطين تحاضر القلاية, وأنهم مستبسلون في حربهم معه مصرين على صرعه .. فبكي .. ووجد راحة في أن يبكي .. وعاد ينظر إلى الصورة مرة أخرى ثم قال في زفرة محرقة (لماذا تتخلي عنّى يارب؟!) ..
وبينما هو يكفكف دموعه, إذا بخشخشة خلف الباب! فإضطرب وإدادات ضربات قبله .. وجمد مكانه لا يبد حراكاً .. ثم إذا بالباب يفتح في هدوء, وشخص طويل مهيب, يشع وجهه ضياءاً, وملابسه بيضاء فوقها وشاح أحمر.
فخاف وحبس أنفاسه, وثبت عينيه على ذلك الشخص, فإذا به يتحرك .. ولقدميه حفيف كحفيف الشجر .. وكالنسيم الهادئ تحرك نحوه – ثم تقدم منه, فصار مبهور الأنفاس ..
ووقف السيد المسيح إلى جواره وإنحني فوقه وهو لا يستطيع حراكاً .. فربت على كتفيه في حنان, ثم قال له بصوت عذب: " .. مالك تبكي .. أتراني قد تخليت عنك .. ثق إني أنا معك .. ".
وإنتبه إلى أن الشخص الذي كان معه داخل القلاية, هو هو السيد المسيح نفسه!!, فإنفجر باكياً .. ليس دموع صغر النفس, وإنما دموع التعزية .. وقد غسلته دموعه في تلك الليلة .. وشعر أنه تعمد من جديد – وهدأ – وهدأت كذلك الأمطار في الخارج .. وسكنت الرياح .. وإنتهي الرعد, وعادت السماء صافية ..
ومنذ ذلك اليوم .. وقد عاش هائماً على وجهه, يأكل أي شيء وينام في أي مكان .. يعمل بلا كلل .. وصار قليل الكلام – شارداً حالماً ... منتظراً ذلك اللقاء ... بثقة.